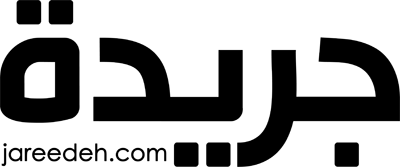د. علي كشت يكتب: زمن الفوضى الذكية والسفسطائية الجديدة

نعيش اليوم في مرحلة تاريخية تتسم بقدر غير مسبوق من الفوضى، فوضى لا تعتمد على الجهل العفوي كما في الأزمنة الماضية، بل على ما يمكن تسميته بـ«الغوغاء الذكية»؛ فئات تملك أدوات التأثير والانتشار، لكنها تفتقر إلى العمق المعرفي والنضج السياسي والخبرة اللازمة للمشاركة في صناعة القرار. ساعدت هذه الظاهرة على صعود «السفسطائية الجديدة»، وهي خطاب يقوم على الجدل العقيم وتزييف المفاهيم، وإيهام الجمهور بالعمق، بينما يكرّس التفاهة ويمنحها سلطة غير مستحقة.
وسائل التواصل وترسيخ الفوضى
لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في تفكيك المرجعيات المعرفية والأخلاقية. فقد تساوى في فضائها صوت العالم مع صوت الجاهل، وصوت الحكيم مع المهرّج، وأصبح الرأي العابر ينافس التحليل المتخصص. هنا تحوّل مفهوم الحرية، الذي يُفترض أن يكون عماد الديمقراطية، إلى إشكالية حقيقية: أين تنتهي الحرية وتبدأ الفوضى؟ ومتى تصبح الحرية المطلقة مفسدة مطلقة؟
وهم المشاركة في القرار
في ظل هذه الفوضى الفكرية، أصبح كثير من الناس يظنون أن مجرد التعبير عن الرأي يؤهّلهم للمشاركة في صناعة القرار. فترى من لا يمتلك أي خبرة سياسية أو علمية أو مهنية يطالب بأن يكون صانع قرار أو مستشارًا في قضايا مصيرية.لقد أصبحنا نرى عامل النظافة أو الموظف العادي — مع كامل الاحترام لجميع المهن — يتحدث بثقة في مسائل استراتيجية معقدة، وكأنه خبير في الاقتصاد أو الأمن أو السياسة الدولية. والمشكلة ليست في حق التعبير، بل في الخلط بين المشاركة بالرأي وامتلاك المؤهلات لاتخاذ القرار.فصناعة القرار مسؤولية تحتاج إلى التكنوقراط وأصحاب الخبرة، لا إلى ضوضاء الغوغاء.
زعماء يثيرون الدهشة
يكفي أن نلقي نظرة على المشهد العالمي لنرى شخصيات تتصدر قيادة دول كبرى، ونكاد لا نصدق أنها هي من تدير مصائر الشعوب. هل يُعقل أن يُنتظر من شخصية مثل دونالد ترامب، بأسلوبه الشعبوي الصدامي وسلوكياته الصبيانية، أن يقود عملية سلام عادلة أو يكون وسيطًا نزيهًا؟ وكيف يمكن أن نأخذ خطاب القيم والأخلاق من رئيس مثل إيمانويل ماكرون، الذي تحوّل في أذهان كثيرين إلى نموذج للتناقض الأخلاقي والنرجسية السياسية؟ نحن لا نتحدث عن حياته الخاصة لذاتها، بل عن رمزية أن يصبح شخص بهذه التركيبة متحدثًا باسم "القيم الغربية".
الاستبداد الديمقراطي
هذا الواقع هو نتاج ما يمكن تسميته بـ«الاستبداد الديمقراطي»؛ نظام يسمح بصعود شخصيات تافهة أو هزلية إلى السلطة باسم الحرية والديمقراطية، بينما يفرغ الممارسة السياسية من مضمونها ويحوّلها إلى استعراض إعلامي. النتيجة: فوضى، اضطراب عالمي، وانهيار في المعايير. تشعر أحيانًا وأنت تتابع القمم الدولية وكأنك أمام مجموعة من المراهقين يتبادلون النكات لا رؤساء دول يديرون شؤون أمم.
وفي المقابل، نرى في أنماط قيادة أخرى — مثل الصين وروسيا — هيبةً وانضباطًا واضحين. هناك يُنظر إلى القيادة باعتبارها مسؤولية تاريخية، لا منصة للجدل أو الشهرة، وتُدار الدولة بعقلية محافظة منضبطة تحفظ مكانة وهيبة القرار.
الحكمة التي هُدمت… والنخبة التي تلاشت
في خضم هذه التحولات الفوضوية، تم تحطيم واحدة من أعمق القواعد التي شكّلت عبر التاريخ ميزان الاتزان الاجتماعي والسياسي:«رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه.» هذه العبارة لم تكن مجرد حكمة أخلاقية، بل كانت تعبيرًا عن فلسفة سياسية عميقة تقوم على إدراك كل فرد لدوره وحدوده ضمن البنية الاجتماعية، وعلى احترام التراتبية الطبيعية بين عامة الناس وأصحاب الخبرة والمسؤولية هذا المبدأ يشكل، في جوهره، ما يسميه علماء الاجتماع السياسي بـ «نظرية النخبة» (Elite Theory)، التي تؤكد أن أي مجتمع مستقر وفاعل يحتاج إلى نخبة حقيقية تقود، وتفكر، وتتحمل مسؤولية اتخاذ القرار. في النظريات السياسية من باريتو وموسكا إلى رايت ميلز، هناك إجماع على أن القيادة ليست وظيفة جماهيرية، بل مسؤولية نخبوية تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة والاتزان. فالنخبة — بمعناها الصحيح — لا تعني طبقة مغلقة أو امتيازًا موروثًا، بل تعني تلك الفئة التي تمتلك المؤهلات الفكرية والسياسية والإدارية لقيادة المجتمع نحو المصلحة العامة. عندما تُحطم هذه القاعدة، وتُلغى الحدود بين من يملك الخبرة ومن يفتقر إليها، يصبح القرار الجماعي فوضويًا، ويختلط صوت الحكيم بصوت الغوغاء، وتضيع البوصلة. وهذا بالضبط ما نراه اليوم: صعود ما يمكن تسميته بـ«نخبة الصدفة» أو «نخبة الضوضاء»؛ أشخاص وصلوا إلى مواقع القرار لا لكفاءتهم بل لقدرتهم على إثارة الجماهير أو استغلال المنصات الرقمية.إن إعادة الاعتبار لمبدأ «رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه» تعني عمليًا استعادة دور النخبة الواعية في توجيه المجتمع، وبناء مؤسسات قادرة على اتخاذ قرارات رشيدة بعيدًا عن العواطف والضجيج. فبدون هذه النخبة، يتحول المجتمع إلى ساحة مفتوحة للصراخ، لا إلى منظومة قادرة على التخطيط للمستقبل.
الخلاصة: إن عصر «الفوضى الذكية» و«السفسطائية الجديدة» لا يمكن مواجهته إلا بإحياء قيم الحكمة، وبناء نخبة حقيقية تتحمل المسؤولية التاريخية في قيادة المجتمع، لا أن يُترك القرار لمن لا يعرف قدر نفسه ولا يدرك خطورة موقعه.